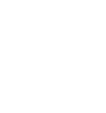شهادة مقابل دورة تدريبية.. هل يبيعنا المدربون الوهم؟
تعليقها على ظاهرة الدورات التدريبية، تروي الكاتبة والشاعرة الكويتية “سعدية مفرح”، حكاية عن إحدى زميلاتها المهتمات بتطوير الذات والدورات التدريبية في هذا الشأن، لتسألها في لقاءٍ بينهما بعد فترة عن ما آل إليه اهتمامها بهذه الدورات. فتخبرها صديقتها أنها -بعد عدد من هذه الدورات- قد أصبحت هي نفسها “مدربة تطوير ذات”، ثم تقول: “ولأنها لاحظت دهشتي مدت يدها إلى حقيبتها وأخرجت منها بطاقتها الصغيرة وقدمتها لي بفخر واضح، قرأت البطاقة فوجدت الأمر أصبح حقيقة، حيث اقترن اسمها بهذا المسمى الجديد”[1].
لتكمل: “وقبل أن أتم قراءة البطاقة بدأت تحكي لي كيف أن أحد المدربين الكبار، والذين كانت لا تفوت له دورة تدريبية إلا وحضرتها، لاحظ إخلاصها الشديد لعالم التدريب، كما أسمته، فعرض عليها أن تصبح مدربة عبر حضورها عددا من دورات تدريب المدربين!”[1]. فهل أصبحت التصورات تجاه حضور الدورات أشبه بشرائنا لمنتج استهلاكي مثلا، أي تصبح قيمة الدورة في مجرد حضورها، لا للعلم الذي تحصّل عليه الفرد وانعكس على حياته الواقعية؟ وهل أصبحت المعرفة سلعةً كما باقي السلع التي تتوافر على أرفف المحلات التجارية؟
في عالم يطغى فيه الاستهلاك، فإن “النزعة الاستهلاكية تجعل الثقافة لا تدرك كوسيلة لتلبية احتياجات، بل لخلق احتياجات جديدة، مع إبقاء عدم الرضا الدائم بالحاجيات المحصل عليها فعلًا”[2]. فتضحي الثقافة والمعرفة لونًا من ألوان الموضة التي يسعى المرء لامتلاكها وتزيين صورته بها، لا لأجل امتلاك المعرفة نفسها.
فالموضة، حسب “زيجمونت باومان”، هي صيرورة دائمة يتأرجح فيها المرء بين الرغبة في الانتماء لمجتمع ما والرغبة في التميز عن عوام الناس[3]، وهو ما يمكن أن تصنعه دورة وهمية لتنمية الذات من خلال تصديرها لموضوعها باعتباره يقدم معرفة حقيقية ستفيد الحضور وتجعلهم أفضل حالًا ممن لا يحضرون تلك الدورة المميزة.
هذا النمط من الاستهلاك الثقافي قد أبدل الملكية الاقتصادية بالملكية الثقافية، ليصبح المرء ساعيًا نحو امتلاك الثقافة، ويصبحَ الإنتاج الثقافي -حسب “جيرمي ريفكن”[4]– بمثابة “المرحلة الأخيرة لنمط الحياة الرأسمالي، الذي كانت رسالته الجوهرية دائما جلب المزيد من الأنشطة الإِنسانية إلى الميدان التجاري”[5]، عن طريق بيع التجارب الثقافية للجماهير.
وهو يرى كذلك تسرّب هذا النمط من التفكير، أي امتلاك الثقافة وشراء التجارب، إلى علاقة المرء بالحياة وتصوراته الإنسانية، “فعملية بيع الثقافة على شكل نشاط إِنساني بأجر متزايد “تؤدي بسرعة إلى عالم تحُل فيه الأنماط المالية للعلاقات البشرية مَحَلَّ العلاقات الاجتماعية التقليدية”[5]. مما يؤثر على تصور المرء نفسه عن الثقافة والمعرفة بوجه عام.
في عرضه لظاهرة المعرفة وتناولها السطحي من قِبل الجمهور، يرى الكاتب “سعد الطائي”، أن وسائل تقديم المعرفة للجماهير قد “اتجهت إلى تبسيط المفاهيم والأفكار والمعلومات في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من فئات الجمهور وعرضها بشكل سهل وسريع وسطحي من دون الخوض في التفاصيل والتعمق في خلفيات الموضوعات أو شرحها شرحًا مفصلًا”[6]. وهو ما تمثله على أرض الواقع العديد من الدورات التحفيزية غير ذات الموضوع، والتي تتميز بالضعف العلمي في كثير من الأحيان.
الأمر الذي عبّر عنه “بيجوفيتش” من قبل بـ”الثقافة الجماهيرية”، قائلًا أن “موضوع أي ثقافة هو الإنسان: فردًا أو شخصية، أي الفردية المتفردة التي لا تتكرر. أما موضوع الثقافة الجماهيرية ودفها، فهو الجمهور أو Man Mass”؛ ذلك لأن الإنسان يملك روحًا، “أما الجمهور فلا شيء لديه سوى حاجاته. ومن ثم، فكل ثقافة هي تنمية للإنسان، بينما الثقافة الجماهيرية مجرد إشباع للحاجات”[7].
فلو كانت الثقافة الحقيقية، الناتجة عن التعلم العميق للفنون والأمور، تنحو تجاه الفردية وتميّز المرء بعلم ومعرفة حقيقيتين، فإن الثقافة الجماهيرية، وفقًا لبيجوفيتش، تصب في الاتجاه المعاكس، فهي تهدف إلى التماثل و”صب الأرواح في قوالب متماثلة”[7]، فالناس هنا منقسمون إلى منتجين ومستهلكين للسلع الثقافية بغرض المعرفة، ولكنها معرفة سطحية غير حقيقية، تجعل الإنسان المستهلك لهذه الثقافة كالطفل الذي يتسلّى بما يتلقّاه من المعرفة السطحية دون الاجتهاد الذي يخوضه المتعلم الحقيقي.
فالمعرفة المستندة إلى القراءة والتفكير المجرد عند الإنسان تعد من الضرورات اللازمة لإنماء الفكر الإنساني بشكل عام وتطويره وزيادة إخصابه[6]، وهو ما لا تحققه الدورات التحفيزية المختزلة بشكل كلي، إذ إن “غالبية المتلقين يكونون ممن لا تساعدهم إمكاناتهم المعرفية والثقافية كثيرًا في هذه المجالات. ذلك أن أغلب المعلومات التي تتلقاها هذه الفئة من الجمهور تكون مجَزأة وبدون تفصيلات كافية تغني الموضوع”[6].
الأمر الذي لا يمكن المتلقي من تكوين التصور الواضح، أو الخلفية المعلوماتية والثقافية التي “يعتد بها كي تؤهله ليصدر حكمًا عن هذا الموضوع أو تكونَ له قاعدة علمية أو رصيدًا علميًا أو ثقافيًا ذا مستوى مرضٍ وذلك بسبب محدودية أو انعدام قراءته لهذه الموضوعات وبالتالي عدمُ امتلاكه للخلفية الثقافية الكافية عنها أو عدم امتلاكه مستوى مقبولًا من المعلومات أو انعدام امتلاكه لها أصلًا… مما ينعكس بالنتيجة على مدى تقبله لها أو مدى الاستفادة الحقيقية منها”[6].
بين الذاتي والموضوعي تختلف النظرة للأمور، فما تنتجه الذات من خلال تجربتها لا يَصْلُحُ للتعميم عادةً، في حين أن ما تثبته الدراسة الموضوعية يمكن له أن يسود، فنفسِّر الأشياء من خلاله أو نُرجِع إليه الأمور. الشيء ذاته ينطبق على الفارق الجوهري بين دورة تحفيزية/تدريبية تتناول قشريات التخصص، وبين العلم الموضوعي الثابت بالدليل.
ففي دورات في اللا-تخصص، كما هو الحال في العديد من دورات التنمية البشرية[8] -وفي غيرها- ثمة فارق بينها وبين العلم المعتبر، القائم “على التجارب المختبرية والمعملية الموضوعية” والتي خضعت “للدراسة والبحث المستمرين لسنوات”[9]، بينما تقف التجارب على خبرات المحاضر، أو الكاتب المرجعي له، “وهذه التجارب لا نستطيع أن نحكم على مصداقيتها”[9].
كما أن العلم “لا يتكلم بلغة العموميات أو لغة الوصفة أو لغة الحديث” وإنما “يتحدث بلغة إجرائية تفصيلية”[9] أما التنمية البشرية -كمثال- “فتتحدث كما هو معلوم بمثالية كبيرة استغلها البعض للاستهزاء والسخرية منها”، فهي تستعمل لغة العمومية، وهي لغة “لا إشكال بها إن كنا نهدف إلى بعث الأمل والطاقة في نفس المقابل بشرط ألا يكون الأمل كاذبًا والطاقة فارغة من مصداقيتها”[9].
فما بين العلم والخرافة تسلك التجربة سبيلًا أحيانًا لتروّج بعض الخرافات في ثوب العلم، لتخبرك عن فلان الذي فشل في حياته، أو ترك جامعته، ثم صار ناجحًا ومليونيرًا، فهم “يصورون الفشل والنجاح على كونهما خطوتين بسيطتين: شخص ما كان هنا وصار هناك هكذا بفعل سحري بلا تفاصيل”[10].
فلو أن الأمر كذلك، فبماذا يستفيد الإنسان محدود الخبرة من مجال لا يدري عنه شيء بمجرد محاضر؟ وكيف يمكن تصدير العلم في ثوب دورة تدريبية تقتني مفاتيح الموضوعات، أو حتى دورات تهدف لتطوير الذات بلا مفهوم واضح لماهية هذه الذات وكيفية التطوير؟ وهل تكفي تجارب المحاضرين، أو من ينقلون عنهم، لتفي بهذا الغرض من دون أساس علمي أو سيكولوجي؟
وعن السبب وراء انتشار الظاهرة، هل أضحت الثقافة سلعة ومادة للاستهلاك لا يشترط جودتها بقدر ما يهم بريقها؟ أم إن المعرفة صارت أبسط من معاناة التعلّم، ليتم منحها من خلال كَبْسُولَةٍ جاهزة يلقيها إليك المحاضر دون تعمق وبحث من الطالب أو الحضور؟ فما بين العلم والتجربة، والخرافة في بعض الأحيان، يستمر السؤال: هل يعني حضور دورة تدريبية بلوغ النجاح؟ أم أن للأمر مشاقَّ ومراحل أكثر عمقًا من ذاك؟
http://midan.aljazeera.net/intellect/sociology/2018/4/22/حضور-دورة-تدريبية-لا-يعني-النجاح